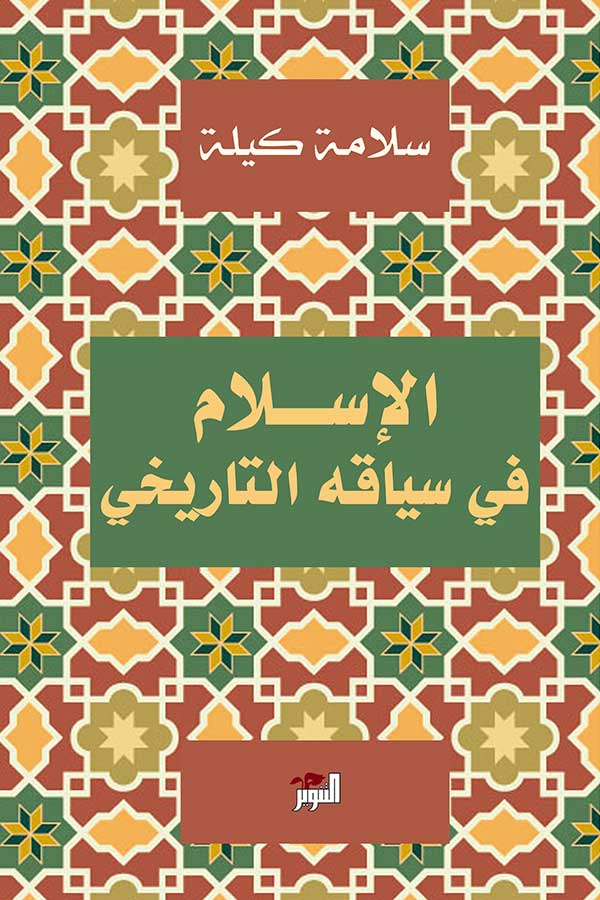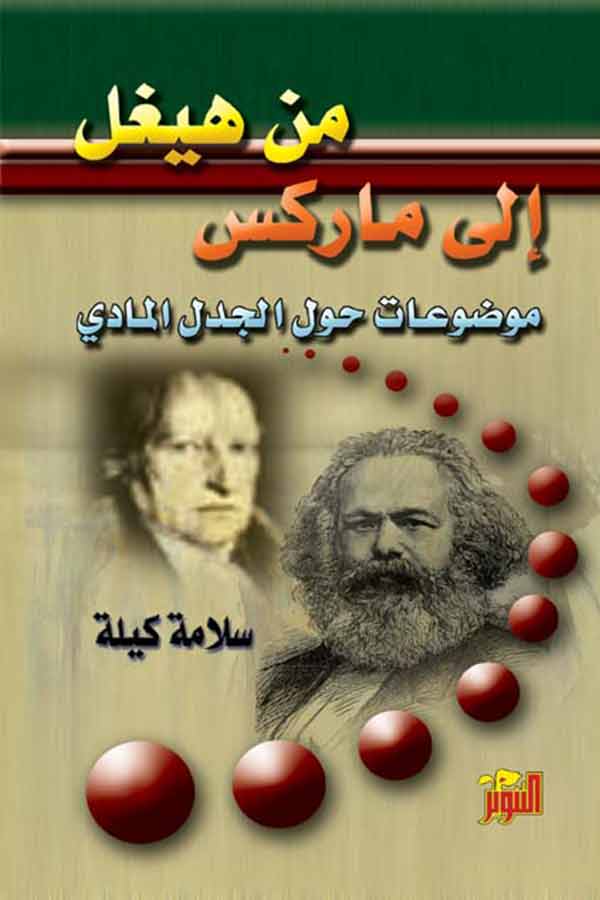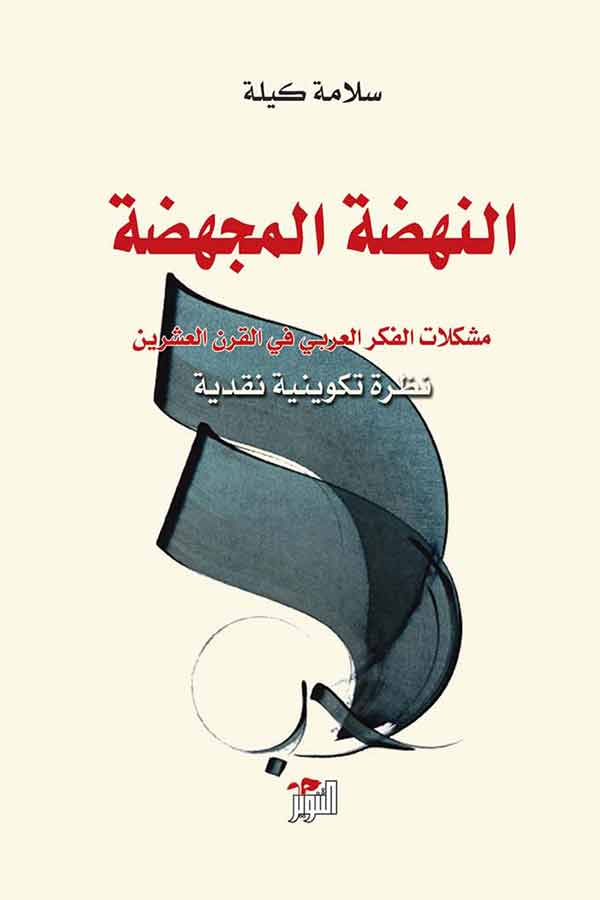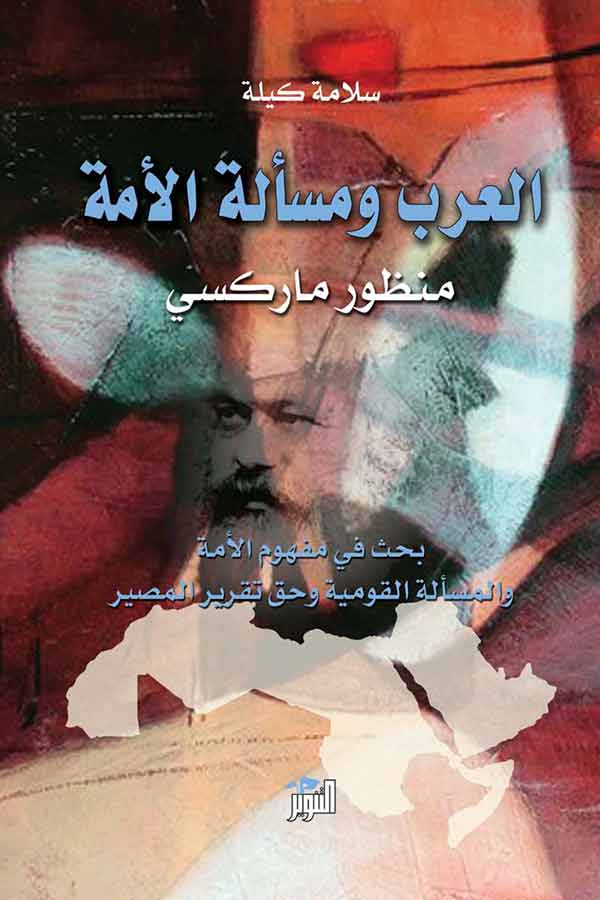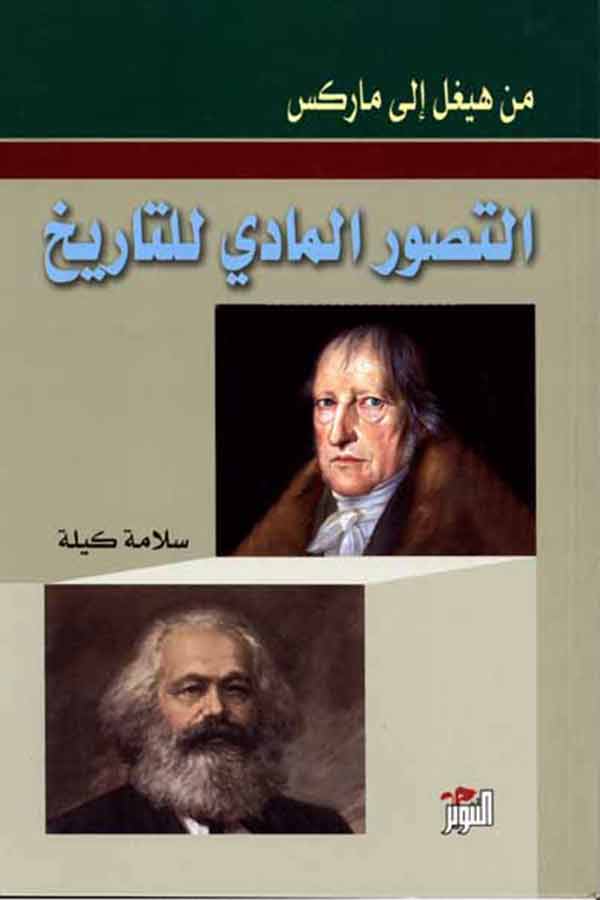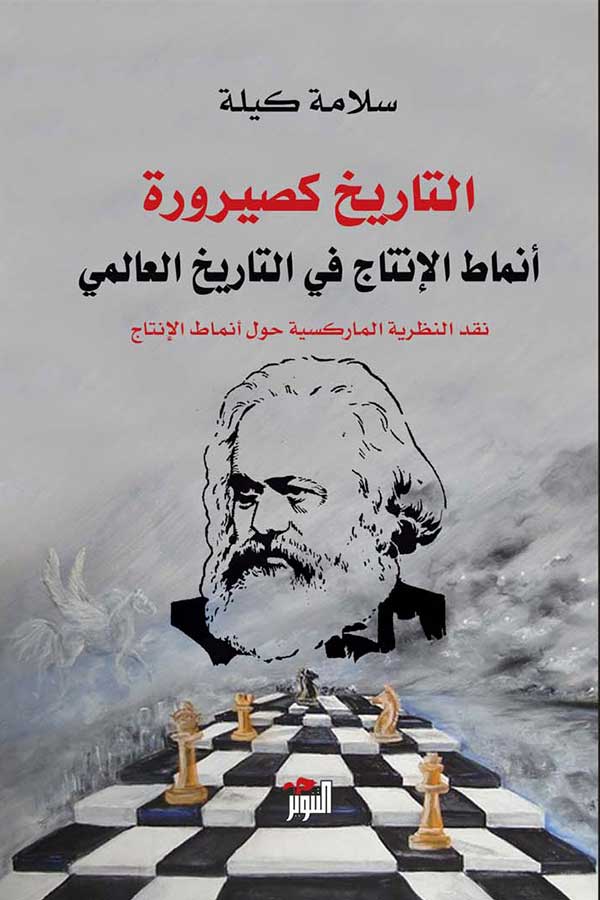النهضة المجهظة
تأليف
سلامة كيلة
على مدى قرنين كان الوطن العربي في مخاض فكري هائل، حيث فتح الاصطدام بأوروبا على مفارقة كبيرة تمثلت في انتقال العالم إلى مرحلة أخرى لم يكن الوعي السائد في الوطن العربي يستوعب أبعادها. فقد كان "الفكر" هو مجرد ثقافة "شعبية"، "عامية"، تتأسس على المعرفة بالنص القرآني، وببعض قواعد اللغة العربية، وكثير من الأساطير التي كانت تربط بالدين. تدرس من خلال "الكتاتيب" التي هي ملحقة بالجامع، ويمارسها الشيوخ الذين لا يمتلكون من المعرفة أكثر مما يدرسون في الغالب.
أما أوروبا فقد كانت في عالم آخر، حيث تطورت العلوم، وانتشر الفكر بمعناه الحديث، وأصبح التعليم متطوراً يشمل مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية. وكان هذا الوضع قد أوصل إلى نشوء الصناعة التي أدت إلى انقلاب هائل في مسار التاريخ البشري، من حيث الدفع بالعلم خطوات أخرى إلى الأمام، وفي السعي لتكوين دولة ومؤسسات لها طابع جديد ينطلق من إرادة البشر في صنع تاريخهم، ولتصبح الدولة هي المعنية بالعلم وتطوير نظام التعليم لتعميمه على كل المجتمع. لكن الأهم هو أن الصناعة جلبت فيضاً من الإنتاج الضروري للبشر، والذي يبحث عن أسواق يحل فيها. كما أدت إلى تطور هائل في الحرب عبر تطوير أدواتها، مما شكل للدول الأوروبية جيوشاً قاهرة.
هذه المفارقة هي التي أسست لكل المخاض الفكري الذي بدأ مع بعثات محمد علي باشا التعليمية إلى أوروبا ولم تتوقف بعدئذ. وكان من الطبيعي أن يكون الصراع الذي نشأ هو صراع بين الوعي التقليدي الذي مثّل أيديولوجية متوارثة منذ انهيار الإمبراطورية العربية، والتي كانت نتاج هذا الانهيار مما وسمها بـ"العامية" والأسطورية وخلطها بالشعوذة، كما حصرها في مستوى ضيق يتعلق كما اشرنا بالنص القرآني واللغة العربية (والحساب)، وأبقاها محملة بـ"قيم" عصر الانهيار. وبين الفكر الحداثي الذي بدأ في التغلغل رويداً رويداً، بعد الانفتاح على أوروبا، ليس مع تجربة محمد علي باشا فقط بل وعبر التواصل الشامي الذي نشأ على ضوء التواصل التجاري، والمغاربي بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر. هذا الفكر الذي حمل قيماً وأفكار جديدة بدت غريبة عما هو سائد، بل ومناقضة له، وتمس بعضاً من "مقدساته".
العرب و مسالة الأمة (منظور ماركسي)
تأليف
سلامة كيلة
كيف يمكن أن نفهم مسألة الأمة في الوطن العربي؟ هذا السؤال طُرح انطلاقاً من الموقف الشعوري أو العفوي من مسألة الوحدة في الوطن العربي. وهي مسألة حساسة وحاسمة في الوقت ذاته، لكنها خضعت لميول طبقية صيغت في تنظيرات أيديولوجية. وأحتدم الصراع حولها طيلة عقود خمسة، قبل أن يخفت الموقف منها وتتفكك القوى التي كانت تتصارع حولها.
بالتالي كان النقاش يبدو مقلوباً. بمعنى أنه بدل البدء من البحث في مفاهيم الوطن والشعب والأمة من أجل تحديد طبيعة التكوين الذي اتخذ اسم: العرب، كان الصراع حول الوحدة العربية هو منطلق كل الأطراف التي لعبت دوراً مهماً لال تلك المدة..
المسألة التي يتناولها هذا الكتاب هي الإجابة على السؤال حول مفهوم الأمة من منظور ماركسي، وبالتالي تناول مفاهيم الوطن والشعب، من أجل الانطلاق من فهم ماركسي للمسألة القومية، وبالتالي وضع مسألة الوحدة في سياقها الموضوعي.
وتأسيساً على ذلك تجري الإشارة إلى مشكلات الفهم الذي ساد لدى الحركة الشيوعية فيما يخص هذه المسألة، لكن الأهم هو المسألة ذاتها. لهذا جرى التطرق لأساس منهجي يتعلق بطبيعة فهم الماركسية ذاتها، كما إلى أساس يتعلق بفهم التاريخ، وأخيراً إلى محاولة فكفكة الفهم الستاليني لمعنى الأمة، هذا الفهم الذي ظل يحكم الماركسية السوفيتية.
الكتاب يتناول مسألة إشكالية وحساسة، وراهنة.
التاريخ كصيرورة-أنماط الانتاج في التاريخ العالمي
تأليف
سلامة كيلة
محاولات ماركس من أجل تنميط التاريخ انطلاقاً من الرؤية المادية للتاريخ كانت بداية محاولات جادة لوعي التاريخ، ولقد حاول ماركس رسم مخططات لارتقاء المجتمعات البشرية انطلاقاً من هذا التنميط، لكن هذه المحاولات تحوّلت إلى «قوانين» وانحسم «الخلاف» حولها، استناداً إلى نصّ لماركس قيل هنا أو هناك. هذه هي الصورة السائدة اليوم.
...حاولت تقديم «صيغة» أخرى حول ارتقاء المجتمعات البشرية، ولقد قدّمتها كخطوط أولية (تحديدات عامة)، خصوصاً وأني بحثت في «العصر الزراعي» دون العصور الأخرى (المشاعة، الرأسمالية..). لهذا سيبدو البحث هنا وكأنه يقدّم فرضيات بهدف المناقشة (وإن كنت سأبدو جازماً في بعض الفقرات)، انطلاقاً من أن الماركسية لم تبلور بعد تصورها حول ارتقاء المجتمعات البشرية، وأن المطلوب هو النقاش الأوفى لمجمل المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع، سواء على مستوى التاريخ الواقعي أو على المستوى النظري المتعلق بأسس تحديد أنماط الإنتاج.
مدخل الكتاب يحدّد موقع الجدل المادي في بلورة الرؤية المادية للتاريخ، وخصوصاً أنني اعتبر الجدل المادي كنه الماركسية، "روحها".
أما الفصل الأول فيحاول تلمّس القانونيات التي تحكم التعامل مع البحث التاريخي، لهذا فهو فصل منهجي إلى حدٍّ ما.
أما الفصل الثاني فهو فصل مقارن لكنه يحاول فهم «العصر الزراعي»، العصر اللاحق للمشاعة ونمط القنص والجني، والسابق للرأسمالية.
والخاتمة تحاول تقديم تخطيطات عامة حول ارتقاء المجتمعات البشرية.